مقدمة شرح:
إلى حد الآن ما تطرقنا إليه هو من
الكلاسيكيات والمداخل للمسؤولية، لكن السؤال الذي يطرح هو: كيف تحوّلت المسؤولية
من النظام البسيط إلى هذا النظام المركب المعقد: هو أكثر مشاكل قانونية وأكثر
أحكام، هجين، شديد التماس مع الواقع الذي نعيشه، وحلوله ليست سهلة؟
هذه الأمور الأولية للمسؤولية، وتبدو من
كلاسيكيات المسؤولية المدنية، وإذا أثارت مشاكل فهي تثير مشاكل بسيطة، لكن هناك
تحولاً كبيراً بدأ من منتصف القرن الـتاسع عشر- ولنتذكر أول عبارة
بدأنا بها: وهي أن "المسؤولية المدنية هي أقرب الأنظمة اتصالاً
بالواقع، ومنازعاتها هي حلول لمشاكل ذلك الواقع"(Constat)-فلنصلح هذا
الكلام... ما الذي جعلنا نقول أن نظام المسؤولية إلى وقت قريب كان بسيطاً، أحكامه
بسيطة، حتى أحكامه ومشاكله قليلة، ولماذا؟ لأنه كان هناك واقع بسيط، لا توجد
سيارات كثيرة، لا توجد مخاطر كثيرة، الناس كانت تتنقل بالعربات فكانت النزاعات
بسيطة على العقارات وأشياء بسيطة، ليست بالقفزة التي هي عليها الآن،
لأننا انتقلنا إلى وقت الثورات المختلفة: ثورة البخار، ثورة الكهرباء، ثورة
الانترنت (المعلومات)، ما غير ملامح المسؤولية المدنية، لدرجة أنه ما كنا نعتبره
من المسلمات التي لا يمكن التغيير فيها، فبفعل هذه المتغيرات أصبحنا نعيد النظر
فيها مرة تلو المرة، لدرجة القول بتكوين منهج جديد للمسؤولية لم نكن نتخيل أننا
سنصله.
فلنرجع
للمحطات الأولى لهذا التحول، كيف استقر نظام المسؤولية من حيث وضعه
للمبدأ؟ في الأول لم يكن هناك مبدأ عام (نظرية عامة للمسؤولية
المدنية)، كانت هناك حالات خاصة فقط، وهذا هو المنهج المعمول به في النظام
الأنجلوسكسوني، فليس فيه مبدأ عام وإنما حالات، نسميها بالإنجليزية "cases"، كالقانون الجنائي، أما الأنظمة اللاتينية وعلى رأسها
القانون الفرنسي فقد كان لديها المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 124 مدني
جزائري، والذي كان منصوصاً عليه في المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي،
فالنظام اللاتيني يضع المبدأ النظري، ويرى القاضي هل توافرت الشروط لقيام
المسؤولية، ويرجع الفضل قبل القانون المدني الفرنسي للفقيه "DOMAT"، هذا الفقيه هو الذي أصّل هذا النظام، فقال
أن: الالتزام بالتعويض لا يجب أن نجعله مرتبطاً بحالات خاصة، هبْ أنه
حصل أمر جديد لم يكن من قبل، فكيف نصنع؟ فيجب البحث عن مبدأ وأصل لنرتكز عليه في
الالتزام بالتعويض، وقد استوحى هذه الفكرة من القانون الكنسي، فقال هذا
الفقيه: "يجب أن لا يُسأل الشخص عن كل الأفعال الضارة، إنما يُسأل
فقط على الأفعال الضارة الذي تسبب بخطئه في إحداثها"، وقال وقتها
أن: واقعية القانون ليست في الأخلاق، فليس كل الأضرار يُسأل عنها الشخص بل يجب أن
نثبت أنه أخطأ، وكان هذا لانحراف عن السلوك (ضابطة السلوك) سلوك الرجل العادي (Le bon père de famille )،
فلما جاء واضعو القانون المدني الفرنسي وجدوا كتابات هذا الفقيه، وخاصة أنه تكلم
عن الإنسانية (L’humanisme)من
منظور مسيحي، لأننا نتكلم أواخر 1700، وبعدها تم النص عليها في القانون المدني
المادتين: 1382 و1383 ، حيث خصصت هاتان المادتان فقط، لأن مشاكل المسؤولية كانت
بسيطة فرأوا أنهما كافيتان، ومع زيادة وتنوع الحوادث أصبحتا ضيقتين على
التطور الحاصل، فأفسح المجال للقضاة يرتكزون عليهما بالتفسير، وهو في
الحقيقة أمر خطير لأنه و في الشريعة اللاتينية الأصل أن القاضي لا يضطلع بمهمة
التشريع.
السؤال المطروح الآن
له علاقة بالتطور لأنه لا يمكن معالجة فكرة المسؤولية المدنية التي هي من المواضيع
التي لا تثبت على حال، وهناك قدر قليل من الأحكام الذي هو عزيز على التعديل،
ويسميها الخبراء بأنها النواة الصلبة لأن التعديل فيها يؤدي إلى
الاختلال، طالما أن هذه المادة في تطور مستمر (لأنها تعكس واقع الحياة المتطورة)،
فسنجيب عن سؤالين أحدهما أبسط وآخر نتعمق فيه، فنتناول تطور المسؤولية، ليس التطور
التاريخي وإنما المقصود المراحل الكبرى، كيف تنظر الأنظمة القانونية لهذا التطور؟
لكن المهم هو السؤال الثاني وهو: ما هي سمات هذا التطور وما هي آثار هذا التطور؟
سنجيب على محطتين: أولاً التعاطي مع فكرة المسؤولية، كيف تعاطت الأنظمة مع فكرة
المسؤولية وما هي المحطات الكبرى؟ هذا الشق الأول، الشق الثاني أثر هذا التطور أو
ما هي المشاكل أو ماذا تمخض عن هذا التطور؟
لا نستطيع أن نفهم أحكام المسؤولية المدنية بسهولة
لأنها غير ثابتة على حال ليس على مدة 20 سنة وإنما في بعض المرات كل سنة أو سنتين
تتغير، فالآن نحن نتكلم عن المسؤولية الإلكترونية الناتجة عن استخدام الانترنت
مثلاً، فلا يمكن إذن أن نتناول أحكام المسؤولية المدنية ونحن لا نعرف التطور الذي
مسها، هذا التطور يجب أن ندرسه من جهتين: الأولى كيف عالجت الأنظمة القانونية
(اللاتينيوجرمانية والأنجلوسكسونية، الشريعة الإسلامية...) المسؤولية؟
*بالنسبة للشريعة الإسلامية عندما ترجع لكتب الفقه لا
تجد مصطلح المسؤولية المدنية، إنما يقابلها "الضمان"
و"التعدي"، أيضاً ورغم أنه في الشريعة يوجد قاعدة "لا ضرر ولا
ضرار" أو "الضرر يجبر" لا نجد بالنسبة للشريعة أن لها نظرية
للمسؤولية إنما منهجها منهج حالات وتسمى في الفقه "النوازل"، مع كل
نازلة القاضي تعرض عليه ويجد لها حل؛ إنما لا يوجد مبدأ ولا توجد نظرية عامة
وشروطها، كالنظام اللاتيني، إنما هي حالات خاصة يتم القياس عليها، فمنهج الشريعة
الإسلامية هو منهج استقرائي يتعلق بالحالات لا ينطلق من مبادئ عامة، مسؤولية تعتمد
على الضرر أكثر من الخطأ (فهي مسؤولية موضوعية) وهذا يعني أن فيها تطور،
فيما يخص العائلة الأنجلوسكسونية فهي قريبة
جداً من الشريعة، لا نتكلم فيها عن مبدأ عام وإنما عن حالات خاصة للإخلال، صحيح
أنه كانت هناك محاولات من فقهاء ومؤلفين جدد في أمريكا وبريطانيا حاولوا نوعاً ما
الخروج عن هذه القاعدة إنما تبقى دائماً هي القاعدة، ورغم وجود مصطلح المسؤولية
بالإنجليزية وهو: (The liability)، ويتكلمون عن الحالات المذكورة والقاضي يرجع لتلك الحالات
ويجعلها من السوابق القضائية، ولكنه لا توجد نظرية عامة، لأن النظام الأنجلوسكسوني
يعتمد المنهج الاستقرائي الذي ينتقل من الجزء إلى الكل، هذا النظام نستطيع أن نقول
أن فيه مزاوجة بين نظرية الخطأ والنظرية الموضوعية، ولكن في
اعتقادنا أنه ساهم بشكل كبير خاصةً القانون الأمريكي في تطور المسؤولية
الموضوعية، ووضع الأساسات الأولى لنظرية المخاطر، وبالتالي القول بأن المسؤولية
الموضوعية وُجدت في هذا القانون.
أما الشريعة اللاتينية فقد كان منهجها مثل هاتين
الشريعتين، ولكن ظهور القانون الكنسي والفقيه "DOMAT"، الذي وضع قاعدة ومبدأ،
وحاول أن يصنع نظرية عامة للمسؤولية التي كانت مبعثرة، وهي نظرية المسؤولية
المدنية التي تقتضي التعويض إذا كان الضرر مترتب عن خطأ، فإذا لم يكن الضرر
مترتباً عن خطأ لا يعوض، أما إذا كان الخطأ قد ساهم بشكل جزئي فيعوض بقدر ما أسهم
به الخطأ من ضرر، فتم وضع قاعدة "عدم الإضرار بالغير" وتم تركيزها على
فكرة الخطأ، أي أننا لا نطلب التعويض من شخص إلا إذا تسبب بسلوكه في ضرر، وبدأ
بوضع ضوابط للخطأ وكيف نقيسه، والحقيقة يمكن القول أن المادتين: 1382 و1383 جاءتا
بنفس الشكل والأسلوب الذي وضعه الفقيه، ومنها استقينا المادة 124 مدني، فالقانون
المدني الجزائري صيغ بعد تحقيق العديد من النظريات مهيأة.
الآن نطرح السؤال: ما هي الأسباب التي دفعت إلى
التطور، كالاتجاه الموضوعي للمسؤولية وهو التطور الأول؟ التطور الثاني هو جماعية
أو جمعية المسؤولية المدنية، التطور الثالث هو ظهور آليات وتقنيات أخرى في التعويض
تزاحم المسؤولية المدنية، فما هي هذه الأسباب؟
الأسباب التي ساهمت في تطور المسؤولية.
*المسؤولية هي في الحقيقة تكلم عن ثنائية "واقع قانون" (Facto-Loi)،
وهو ما يدرس في الغرب الآن ( L’intelligibilité
de la règle de droit)
أو "ذكاء القاعدة القانونية"، بأن يكون لها القدرة على استيعاب واستشراف
الواقع، فالعلاقة بين الواقع و القانون هو المجال الخصب للمسؤولية؛ ومن هنا يمكن
إرجاع أسباب تطور المسؤولية إلى ما يلي:
1-التحول الجذري للمجتمعات بداية من القرن التاسع عشر بفعل: الثورة الصناعية،
والميكنة، وميكنة النشاطات الإنسانية التي أنتجت ظاهرة جديدة لم نألفها سميت "ظاهرة
الحوادث"، هذا التحول المرتبط بهذا الواقع الجديد ترتب عنه مشاكل
قانونية جديدة، وعوض الكلام عن المسؤولية الناتجة عن فعل وخطأ الإنسان،
أصبحنا نتكلم عن المسؤولية الناتجة عن فعل الأشياء أو الأضرار الناتجة عن الحوادث:
حوادث العمل، حوادث المرور وهلُّم جرا...؛
2-بالنظر إلى هذه الحوادث ذات التكلفة العالية في الخسائر (البشرية أو
المادية...)، أصبح من الصعب على الإنسان قبول الضرر الناجم عن فعل الطبيعة وفعل
الصدفة "Le fais de hazard" (لأنه في
السابق كان عند وقوع حادث عمل يصعب إثباته لم تكن تُقام المسؤولية، ففي فياضانات
باب الواد و زلزال بومرداس مثلاً، وحادثة لقاح التطعيم ووفاة رضع في واد الأبطال
بمدينة معسكر، قالوا أنه القدر ومشيئة الله، ولكنه ليس فقط قدر الله وإنما خطأ
البشر وتسييرهم وإهمالهم وعدم الوعي الذي زاد من فاتورة الخسائر، لهذا فإن الفرد
في الدول المتحضرة التي تحترم نفسها، أصبح لا يقبل عدم تعويضه لأنه قدر الله)، وخاصة بعدما أصبح مبدأ تثمين قيمة الإنسان وتقديره مبدأً دستورياً
راسخاً في القوانين الحديثة.
فقد ظهرت مع هذا الاتجاه فلسفة جديدة، فلسفة أنه "مع كل ضرر يجب
أن يكون هناك تعويض"، ولا يجب أن يكون الشخص المتعرض للضرر أياً كان بدون
تعويض؛
3-المعروف أن بوصلة المسؤولية كانت تتجه نحو المسؤول، أما الآن فقد أصبحت تتجه
نحو المضرور. في الأول كنا ننظر للمسؤول هل أخطأ أم لم يخطئ ؟هل لديه الملاءة أم
لا؟ ونحاول إنقاذه فلا يعوض إلا في حالات قليلة، ومع هذه الموجة والثورة الجديدة
في الكتب
الفرنسية (les métamorphoses)
التحولات الكبرى للمسؤولية المدنية منها: تحول البوصلة من المسؤول (المدين
المفترض) إلى ناحية الضحية، وظهر مفهوم جديد هو (La victimologie)، وهو علم يهتم بدراسة الضحية وظروفه أكثر من الاهتمام
بالمدين المفترض، هذا التطور الجديد كان مرتبط بتراجع فكرة الخطأ وظهور نظرية
المخاطر (المسؤولية الموضوعية)، وأصبح هناك إعادة نظر في أساس المسؤولية، ففي
السابق كنا نقول: "يعوض من تسبب بخطئه في ضرر"، أصبجنا الآن نقول:
"يعوض من أحدث ضرر"، أو "من تسبب بالأخطار التي يحدثها في
ضرر"، أو "من يغتنم من الشيء فيجب أن يغرم"، وبدأنا نتكلم عن
ثنائية أخرى هي (Risque-profit)
أو" الربح-المخاطر"، أي بنشاطه المربح الذي يحوي الكثير من المخاطر،
فإذا حدثت أضرار نتيجة هذه المخاطر يعوض، فلم يصبح اهتمامنا من هو المسؤول عن
التعويض، فقد أصبح موضوعاً بديهياً، لأننا أصبحنا نقول:" مع كل ضرر هناك
تعويض"، وظهر بعد هذا التساؤل سؤال آخر أكثر إلحاح، لأن الشق الأول:"
متى نعوض ولماذا؟" قد انتهى، اشتغلنا على فكرة أخرى وهي: كيف نعوض؟ كيف نوفر
الملاءة التي تكفي للتعويض؟ كيف نوفر الاقتدار المالي لنكون جاهزين
للتعويض؟ وهذا ما يدرس في أوربا الآن،
الأسباب هي
كثيرة لكننا اختصرنا أهم الأسباب، إذا هذا هو الواقع، فكيف تعاملت قواعد المسؤولية
مع هذا الواقع؟ إلى جانب هذا الواقع بدأت تظهر بعض المؤسسات لا هي
قانونية أو
اقتصادية...، ظاهرة التأمين من الصعب القول أنها واقع أم قانون، لأنها حقيقةً في
البداية ظهرت كاستجابة للواقع وكأن الواقع هو من صنعها، في كل المجالات... الواقع
أن الذين يشتغلون في مجالات معينة عندما تقع مسألة لا يستطيع فرد ما منهم مواجهتها
لوحده، فتضافروا
بواسطة (Le mutualisme)
التجمع وجمع الذمم المالية لمواجهة هذه المسألة، ثم تحولت إلى مؤسسة قانونية، وقد
لعبت دوراً كبيراً في هذا التطور الذي مس المسؤولية.
فالملمح أو المظهر الأول لتطور المسؤولية هو:
الاتجاه الموضوعي للمسؤولية المدنية، أما الملمح الثاني فهو: ظهور آليات جماعية
للتعويض، صحيح هذين الملمحين يعطوننا انطباعاً عن وجود جانبين سلبي وإيجابي:
- الإيجابي يتمثل في: أن الاتجاه الموضوعي للمسؤولية
أراح المضرور من عبء الإثبات، وأراح القضاة الذين كانوا يتعاطفون مع الضحايا ولا
يجدون الأساس، السبيل لإسعاف هؤلاء الضحايا، لأنه بدأ كاتجاه قضائي ثم
سرعان ما أصبح فقهياً وقانونياً، هذا الاتجاه الموضوعي غير ملامح المسؤولية
المدنية ليس فقط من الناحية النظرية، وإنما عند تحريك المسؤولية المدنية، فسهل على
المضرور رفع الدعوى، وسهل على القاضي الحكم بالتعويض، وأكثر من ذلك أنه سدّ
المنافذ ضد المسؤول، لأنه قلص من الدفوع، فأصبحت ضيقة النطاق، فأصبح المسؤول يجد
صعوبة كبيرة في التنصل من المسؤولية، وأصبح يفكر في تقنيات أخرى كيف يحضر المال
اللازم (الخزان) للتعويض،
-ومن الناحية السلبية أو التحديات التي واجهت هذا
التحول، وهي أزمة المسؤولية المدنية لأن هذا التوجه أفرغ المسؤولية من محتواها،
لأن المسؤولية في الأساس تقوم على الاعتبار الشخصي، لأن الإنسان لا
يعوض إلا إذا أخطأ، والأزمة الأعمق أن فكرة المسؤولية المدنية ارتبطت بفكرة زواج
كاثوليكي (ما ربطه الرب لا يفكه إلا الرب) بين المسؤولية والتأمين، فإذا وقعت أزمة
في التأمينات (وقد حدثت كثيراً) تقع أزمة في التعويض أيضاً، وأصبحنا نتكلم عن أزمة
المسؤولية، أصبحت وظيفة المسؤولية المدنية الأساسية، وهي: الهدف التعويضي يضرب في
الصميم، لأن أغلب المال مصدره التأمينات، فلما تقع الأزمات بضرب صناديق التأمين
تقع مشكلة في التعويض، ليس هذا فحسب، بل وضعية المسؤولية في انتكاسة تفقد وظيفتها
لمصلحة التأمين، وأصبح ليس للمسؤولية اعتبار، فالأزمة أن مشاكل التأمين أصبحت تؤثر
على المسؤولية، كذلك بدأت تفقد وظيفتها؛
ننتقل إلى المظهر الثاني، هذه الفكرة أنه عملية
ظهور آليات جماعية، ولا نقصد بها التأمين فقط، بل ظهرت صناديق الضمان في كل
المجالات: حوادث المرور، حوادث الاستهلاك، حوادث الطيران، فهناك ظاهرة جماعية أو
جمعية آلية التعويض بعد أن كنا نتكلم عن آليات فردية، تعويض المسؤول أو أنه يؤمن
عن نفسه أصبحنا نتكلم عن آليات جماعية للتعويض، فأصبحنا نرى التعويض من جانب آخر،
ونبحث عنه في صناديق التعويض، وتكفل الدولة وليس المسؤول، فأصبحت الدولة تعوض لأن
المبلغ كبير، وانتقلنا من فكرة التعويض إلى فكرة أخرى هي الإسعاف أو
التضامن الاجتماعي، عن طريق آليات أخرى تبتعد عن فلسفة المسؤولية، فأصبحت
الخزينة العمومية تعوض، حتى في أساس التعويض أصبحنا نتكلم عن التضامن الاجتماعي
وندرسها في باب المسؤولية المدنية[3]؛
****************************************
ثانياً: أزمة ومستقبل المسؤولية المدنية.
التطورات الأخيرة التي عرفتها فكرة
المسؤولية المدنية صحيح أنها سمحت بتعزيز فرص المضرور بالتعويض، ولكنها في المقابل
تثير بعض التخوفات والانشغالات التي تبدو في كثير من الأحيان مشروعة خاصةً لما
نعلم أنها تساؤلات ذات صلة بمفصليات المسؤولية المدنية، كما أنها
تثير عديد الأسئلة غير المنتهية فيما يخص هذه المؤسسة، أو بمعنى آخر يجب الإجابة
عن سؤال مهم وهو: هل هنالك أزمة للمسؤولية المدنية وفيما تتمثل؟ ثم لاحقاً على ضوء
هذه التجاذبات ما هو مستقبل فكرة المسؤولية المدنية؟ وهل يمكن الاستغناء عنها
والاستعاضة بآليات أخرى بإمكانها تقديم نفس الدور الذي تضطلع به؟ سنحاول مناقشة
هذه الأسئلة الحرجة عبر محورين:
-مكانة ودور فكرة الخطأ؛
-التهديد الذي باتت الآليات الجماعية تمثله لهذه الأخيرة.
مكانة
ودور فكرة الخطأ في المسؤولية المدنية.
الأمر يتعلق بأحد المشكلات الرئيسية وهو أساس
المسؤولية المدنية، ولما نتكلم عن الأساس القانوني للمسؤولية المدنية الأمر يتعلق
بالإجابة عن سؤال هام وهو: لماذا يلتزم المدين
بالتعويض؟ أو بمعنى آخر ما الذي يجعل الذمة
المالية لشخص "أ" مدينة للذمة المالية للشخص "ب"؟ هل لانحراف
سلوك المدين عن المسلك المعتاد المطلوب (رب العائلة المتوسط)، أو بالمقابل هو
يلتزم بغض النظر عن انحراف سلوكه؟ أو بمعنى آخر على ضوء الخطر الذي يلحقه بالغير؟
هنا علينا التعرض إلى محطتين: المحطة الأولى يسميها الفقهاء بفترة: ازدهار
فكرة الخطأ كأساس، أما المحطة الثانية فيتكلمون عن: تراجع فكرة الخطأ
لمصلحة فكرة المخاطر.
المرحلة الأولى: فكرة الخطأ.
ويمكن اختصار هذه المرحلة بفكرة جوهرية مؤداها
أنه لا يلتزم أي شخص بالتعويض إلا إذا تسبب إخلاله العقدي أو التقصيري بإلحاق ضرر
بشخص آخر، حينها تصبح ذمته مدينة لذمة الدائن بقدر الافتقار الذي أحدثه لهذا
الأخير، وهنا نتكلم على تقنية المسؤولية المدنية كوسيلة لاستعادة التوازن المفتقد
بعد وقوع الإخلال، ولقد استطاعت هذه الفكرة في بادئ الأمر ببساطتها أن تقدم إجابات
واستجابات مناسبة بحق المضرور في التعويض خاصةً، وإن الأمر قد ارتبط في القرن
التاسع عشر بمجتمع زراعي وحرفي فلم تكن المخاطر الجديدة قد ظهرت، وكان من السهولة
بما كان إثبات السلوكات الخاطئة، وبمعنى آخر فإن المضرور رافع الدعوى لم يكن يجد
صعوبة في إثبات خطأ (انحراف سلوك) المسؤول، ولما كان دوام الحال من المحال، ووفق
ما تم تناوله سابقاً من تطورات فإن المدنية الجديدة المصحوبة بالثورة الصناعية
والميكنة التي سيطرت على حياة الإنسان المعاصر ساهت في تنامي الأخطار، وأصبح من
الصعب تحديد المسؤول عن الضرر: هل من فعل الإنسان أو الآلة؟ دونما نسيان ظهور موجة
الديمقراطية والتي في الأغلب الأعم جعلت لشرائح المضرورين آذان صاغية من حيث مطلب
التعويض، ومن حسن الطالع أن هذه التحولات العميقة ترافقت مع ظهور التأمين الذي بدا
وكأنه خير معين وعاذر لفكرة المسؤولية المدنية، وحينها بدا المبدأ المعروف"مع
كل ضرر هناك تعويض" مهيأ حقيقةً وفعلاً للتحقيق والإعمال، والمحصلة أن الواقع
الجديد بات يطرح نفسه على واقع المسؤولية المدنية، والذي بات مطالباً بتغيير جلدته
وآلياته ليستجيب لهذا التحول، فأصبحت فكرة الخطأ محل شك وقاصرة ولم تتمكن من إبداء
ذات القدرة التي كانت تبديها سابقاً، وكثرت الأسئلة التي لا إجابة لها، فازدادت
الهوة بين قانون متهالك وواقع جديد يبحث عن قانون حديث، وهنا بدأنا نتكلم عن تراجع
فكرة الخطأ.
المرحلة الثانية: تراجع فكرة الخطأ (ظهور فكرة المخاطر).
يرجع الفضل للفقيه "SALY" لإظهار فكرة المخاطر كتقنية جديدة يمكن أن تؤسس
عليها فكرة المسؤولية المدنية، وفكرة المخاطر تقوم على مبدأين: المبدأ الأول
"الغرم بالغنم" ومؤداه أن من يغتنم من نشاط ما ويتربح منه يتعين عليه أن
تنشغل ذمته بضمان ما يترتب من أضرار عنه أي المغارم، ووجد هذا المبدأ التطبيق
الجيد من قبل القضاء الفرنسي في حوادث العمل، أما المبدأ الثاني فهو مبدأ
"الخطر المستحدث " و مؤداه أنه من يتسبب بنشاطه في إحداث مخاطر تنجر
عنها أضرار فإنه يلزم بضمان وتعويض هذه الأخيرة، ولعل أهم ما يتم التركيز عليه هنا
هو أن فكرة المخاطر هذه بدأت شيئاً فشيئاً بالاتساع: بدأت بحوادث العمل، ثم حوادث
المرور، ثم الحوادث الطبية، ثم حوادث الاستهلاك، ثم حوادث البيئة وغيرها من
الميادين المهنية، هذا ويلاحظ أن تراجع فكرة الخطأ بدأ في الأول يركز على قرينة
الخطأ التي بدأت في الأول بسيطة ثم تطورت وأصبحت قاطعة، وساعدت هذه الفكرة في قلب
عبء الإثبات من المضرور إلى المسؤول عن الضرر، لكن أهم تحوّل حدث في أساس
المسؤولية هو الانتقال في النظرة إليها من كونها علاقة بين شخصين
(المسؤول-المضرور) إلى اعتبارها علاقة بين ذمتين، ليس هذا فحسب بل الأخطر من ذلك
أن فكرة المسؤولية المدنية بات ينظر إليها على أنها آلية اقتصادية واجتماعية
للتكفل مادياً بالمخاطر .
والمحصلة المنتهى إليها أن فكرة الخطأ إذا كنا
ندعي أنها لم تنته فإنه على الأقل باتت لا تعتبر الأساس الوحيد للمسؤولية المدنية،
فهي على رأي أحد الفقهاء:" أساس ضروري للمسؤولية المدنية ولكنه غير
كاف".
شرح: القضية تتعلق بمكانة ودور فكرة الخطأ في المسؤولية المدنية، لنربط مكانة
الخطأ بنقطة الإنطلاق ونقطة الوصول، وعند معرفتهما نستطيع وضع خط يربط بين
المحطتين: المحطة الأولى عندما كان الخطأ الأساس الوحيد لفكرة المسؤولية، فلما
نتكلم عن أساس المسؤولية نحن نريد الإجابة عن سؤال لماذا تلتزم ذمة مدين اتجاه ذمة
دائن بالتعويض؟ أو ما هو المبرر الذي يجعل ذمة شخص مدينة بالتعويض لآخر؟ هل لأن
سلوك المدين كان فيه خلل، وهذا الانحراف هو الذي بسببه وقع الخلل (ذمة الدائن وقع
لها افتقار)، مثلاً بسبب سلوك سائق السيارة بعدم احترام الإشارة وقع لسيارة أخرى
ضرر، فهنا نتساءل لماذا صاحب هذه السيارة ملزم بالتعويض؟ هل لأنه لم يتصرف وفق
ضوابط السلوك المطبق في القانون؟ (سلوك الرجل العادي)، في الأول كانت قاعدة أنه لا
يلزم بالتعويض إلا من أخطأ، إذا لم نثبت خطأ الشخص المطالب بالتعويض فلا يمكن أن
نلزمه بالتعويض حتى ولو بقي المضرور بدون تعويض، وقتها كانوا يتكلمون عن أمر يسمى
"Real juridique"
الواقعية القانونية أو العدل التقريبي، لأن الصناعة كانت في بدايتها والإنسان كان
فرحاً منبهراً بالتقدم، فكانوا يتكلمون عن التعويض التقريبي الذي لا يوقف التطور،
فيقبل التضحية بالمضرورين ولا يقبل إيقاف التطور، فكانت هذه الفكرة هي المناسبة
وتعطي الإجابات المقبولة، ولم تكن تتطلب أعباء كبيرة فكانت الصناعة وليدة (القرن
الـ19) ، وكان الإنسان يبحث عن أشياء تحسن حياته، مع البداية كانت المخاطر أقل
والمشاكل كانت مقبولة لكن ازدياد الصناعات جعل ازدياد المخاطر. كذلك، المجتمع بدأ
في التطور فكنا نتكلم عن الملك والدولة كما كان يقول القيصر: "الدولة أنا
وأنا الدولة"، وبعد الثوارت (كالثورة الفرنسية) والتحرر الفكري والعقلي في
أوربا، بدأنا نرى أن مجتمعاً آخر بدأ في الظهور ، فبدأت الديمقراطية وأصبح الرئيس
الذي كان ملكاً والشعب عبيد، بدأ الكلام عن الحكم بالوكالة: فالرئيس أو رئيس
الحكومة يخشى الشعب حقيقةً لأنه هو من نصبه وهو من يخلعه، وبدأت الأحزاب تناضل
حقيقةً وفعلاً من أجل التغيير، ومن أهم المطالب التي كانت بداية القرن العشرين أن
هناك شرائح كبيرة تعرضت للمخاطر: العمال في المصانع، المارة في الطرق، المرضى في
المستشفيات وهلُّم جرا...، كلهم يرفعون مطلباً جوهرياً: أنه في كثير من الأحيان لا
يجدون التعويضات، وخاصةً أنه القارة الجديدة (أمريكا) كانت متطورة وتحركت قبل
أوربا. في محصلة الأمر، فإن مطلب التعويض ومطلب الاهتمام بشرائح المضرورين
والمصابين زاد وأصبح في مقدمة المطالب، وأصبح مغازلة الوعاء الانتخابي يرتبط بهذه
التعهدات، فالرئيس كندي مثلاً كانت حملته تقوم على هذا، فقد أصبح هناك مجتمع جديد
يطالب بقانون جديد -عوض القانون المهترىء- يستر عوراته، خاصةً أنه من الناحية
النظرية بدأت تظهر نظرية جديدة في المسؤولية، وهي "نظرية المخاطر"،
فأصبحنا ننتقل من التعويض بسبب الانحراف في السلوك إلى التعويض بغض النظر عن هذا
الانحراف، إنما يكف فقط أن تغتنم من نشاط حتى ولو لم تكن مخطئاً فتلتزم
بالتعويض، مادام أنك تربح فتتحمل التبعة وهي قاعدة: "الغرم بالغنم"، حتى
ولو اتخذت كل الاحتياطات المطلوبة، وأول تجسيد لهذا المبدأ كان في القضاء الفرنسي
في الحادثة المعروفة بحادثة "تيفال" في 1792 ، والقضاء رغم أنه لم يكن
منصوص عليها، رجع إلى المادة 1382 الخاصة بالانحراف في السلوك وقال: "رب
المصنع ملزمٌ بتعويض حوادث العمل بغض النظر عن إثبات الخطأ لأنه يغتنم من
نشاطه"؛ وارتبطت بحوادث العمل في البداية ثم بدأت تتطور في كل الميادين
المهنية، وأصبحت من الأسباب الرئيسية لتراجع فكرة الخطأ، بالإضافة لتغير الواقع
والمشاكل الجديدة للميكنة والعصر، وهذه النظرية أصبحت أقرب للواقع فيما نظرية
الخطأ وفي بعض الفرضيات أصبحت عاجزة، لهذا قال أحد الفقهاء "ارموا
بنظرية الخطأ إلى البحر" لأنها أصبحت مهترئة[4]؛
أما المبدأ الثاني لنظرية المخاطر فهو أحدث، حيث أصبحنا لا نقول: "الغرم
بالغنم" وإنما "من يحدث أخطار جديدة يلزم بالتعويض"، ومظاهر
التراجع أو مؤشراته تظهر في: أن فكرة الأساس، أي الخطأ ومن حيث اعتباره كأساس يبرر
التعويض، من أساس وحيد وأوحد، أصبح الخطأ مبرر في بعض الحالات ولكن ليس كل
الحالات، مطلوب نعم، ضروري، ولكنه غير كافٍ، فنجد إلى جانبه فكرة المخاطر، ليس هذا
فحسب، لكن فكرة المخاطر كل يوم تسحب البساط من تحت أقدام فكرة الخطأ، وتأخذ على
حسابها أرضاً جديدة، هذا هو التراجع، على الأقل نستطيع القول من هذه الناحية عوض
أن يكون هناك أساس وحيد أصبحنا نتكلم عن أساسٍ آخر، وهذا أهم مؤشر، وأكثر من ذلك
فإن فكرة المخاطر في بعض المرات، البعض يقول أصبحت تبتلع هذا الأساس، والذي جعل
فكرة المخاطر تنمو وتزداد أن التأمين بدأت تزيد قيمته، ففكرة المخاطر
جيدة بشرط وجود قطاع تأمينٍ قوي جداً، فحينها نجد هناك ملاءة مالية (La solvabilité)؛
*هناك انشغال كان يطرح بعد هذا التحول هو: هل نجد مخزوناً مالياً كافياً
للتعويض؟ لأن هناك حوادث كبيرة (كحوادث الطيران)، لتعويض حجم الأضرار الكبيرة[5].
المؤشر الآخر هو في الحقيقة أن المضرور كان يجد عقبةً أمامه، تحول دون وصوله
للتعويض وهي: "الإثبات ( أي إثبات خطأ المسؤول عن الضرر)، أما الآن وشيئاً
فشيئاً بدأنا نزيح هذه العقبة، على الأقل قلبنا عبء الإثبات، فعوض أن يثبت المضرور
أن المسؤول قد أخطأ، أصبحنا نقول للمسؤول أثبت أنك لم تخطيء، فانتقلنا من قرينة
براءة ذمة المسؤول إلى قرينة انشغال ذمة المسؤول، فمن افتراض براءة ذمة المسؤول عن
التعويض إلى انشغالها، فهو من يثبت الآن أنه لم يخطئ، لأنه الأقدر على ذلك لا
المضرور، الذي يكون ضعيفاً في الغالب، فإذا لم يستطع أن يثبت أنه لم يخطئ فهو ملزم
بالتعويض.
الآليات الجديدة البديلة.
*تكلمنا عن تهديدات الأنظمة البديلة، وسنعالج ما هي الآليات والتقنيات التي
يعبر عنها أنها "Alternatives" بديلة؟ وهذه
الآليات الجديدة البديلة (الآليات الإجتماعية: التأمين على المسؤولية، التأمين
المباشر"Le mutual"، ثم صناديق الضمان،ثم
تكفل الدولة)، صحيح أنها تقدم بعض المساعدة للمسؤولية المدنية، ولكنها في نفس
الوقت تهدد المسؤولية المدنية في الوظيفة، لأنها أصبحت تقوم بدورٍ هو في الحقيقة
دور أصيل للمسؤولية، وهو الوظيفة التعويضية: جبر الضرر الإصلاح...، وأصبحت الآليات
هي التي تحل محل المسؤولية، ليس هذا فحسب بل أصبحنا في بعض المرات نتكلم عن
التعويض المطلق الآلي، وباتت المسؤولية المدنية وكأنها في تراجع في المكان، وبدأت
الآليات تحل محلها، لذلك تحولت في كثير من الأحيان هذه الآليات من بديلة إلى آليات
أصلية وتأتي المسؤولية في أدوار أخرى، فهل هذا الكلام حقيقة؟ وما مقدار مصداقيته؟
وهل في كل الأحوال؟ هل هذا الأمر سيزداد أم يقل؟ طبعاً فإن هذا الكلام يرتبط
بالتحولات التي درسناها، ومن أهمها الطابع الموضوعي للمسؤولية والتخلي عن فكرة
الخطأ، ومن التحولات أن التأمين أصبح يتصدر المشهد، وأن مطلب التعويض أصبح لا
يتعلق بالأفراد بل أصبح مطلباً جوهرياً دستورياً تقوم عليه مختلف الأنظمة، فأصبح
إحساساً أو حالة دستورية، الأمر الآخر أن المسؤولية المدنية في حد ذاتها أصبحت لا
تستطيع أن تقدم بقدر مقبول ما نحتاجه من استجابة، لهذه الحوادث الكبيرة، وأصبح
فيها فراغ، فيبقى ضحايا بدون تعويض، فالآليات ظهرت بتراتبية: ظهرت في
التأمين على المسؤولية وأخطر ما فيها أنها حولت المسؤولية: العلاقة بين شخصين إلى
علاقة بين ذمتين، كذلك فإن المسؤول عن التعويض يحتجب وتظهر شركات التأمين،
ويقال إدارة شركة التأمين لملف التعويض، فتجد محامي شركة التأمين أمامك ولا يظهر
المسؤول، شيء آخر: أصبحنا نجد الدعاوى أمام القضاء تقبل بيسر، ويحصل الضحايا على
تعويضات جيدة، لأن ما كان يصعب على القضاء في السابق أنه لم يكن يجد ذمةً مالية
كافية لتحمل التعويض.
ظهور الآليات الجماعية.
ظهور هذه الآليات مرتبط
بمسببات، أهمها هو الاتجاه الموضوعي للمسؤولية المدنية الذي بدأ يركز على فكرة
المخاطر والضرر، ثانياً هو تزايد وتنامي التأمين وظهوره كفكرة قوية وفر لنا المال
الذي نقدمه للمضرورين ورفع الحرج عن القضاء، فلما ظهر التأمين وجد ملاذاً يلجأ
إليه، ومورد مالي جيد وكافي، وكانت البداية في القضاء الأمريكي، وأصبح يحكم
بتعويضات جيدة على عكس السابق، وهنا ظهرت فكرة التأمين على المسؤولية، وهو قسم من
التأمين على الأضرار (وهناك التأمين على الأشخاص، ونجد التأمين على الذمة المالية
في جانبها الإيجابي، والتأمين على الذمة في جانبها السلبي)؛
التأمين على المسؤولية هو: أن مؤسسة أو شخصاً
ما يذهب إلى شركة التأمين ويطلب منها أنه وفي كل القضايا التي ترفع ضده مطالبة
إياه بالتعويض، فإن شركة التأمين هي التي تتكفل بالتعويض، وتضع له قيمة بوليصة
التأمين التي يدفعها كل شهر أو سنة... (بوليصة التأمين لها حدودها: السقف الأعلى
والأمور التي لا تضمنها...)، وبعد إبرام هذا العقد، أي ضرر يتسبب فيه الشخص إذا
راعى الشروط، تحل محله شركة التأمين في التعويض وحتى في إدارة الدعاوى، والفقه
يقول أن التأمين على الشق السلبي للذمة المالية، فهذا بموجبه تصبح شركة التأمين
مسؤولة عن الدعاوى التي ترفع، ومسؤولة عن مبلغ التعويض...؛
هناك من قال أن فكرة
التأمين على المسؤولية ساهمت في إضعاف المسؤولية المدنية، لماذا؟ أحد الفقهاء
الفرنسيين قال: "التأمين على المسؤولية أخرجت المسؤولية المدنية عن طبيعتها
وشوهتها"، فهي فكرة تشجع على التهاون وعلى تزايد حالات الإضرار بالغير، وتفرغ
فكرة المسؤولية من مضمونها لأن فكرة المسؤولية في الأساس تقوم على الإحساس
والمسؤولية الشخصية، وتعتبر كوسيلة للتهديد، وكأننا نشجع حالات الإهمال والتقصير
والرعونة، من يقول هذا الكلام هو لا يعرف التأمين، فالتأمين ليس جمعيةً خيرية، لأن
هدف التأمين ومحركه هو الربح، فعند طلب بوليصة التأمين تراقب مؤسسة التأمين سوابق
الشخص، مثلاً هل ارتكب حوادث أم لا؟ هل سلوكه جيد؟ وحسب ذلك، فهي تدرس الحالة
جيداً وترى تلك الحالة بأي كلفة، وهل الصفقة مربحة، وكذلك تقوم شركة التأمينات
باستثناءات كأن لا تؤمن على الأخطاء الجسيمة، ماعدا التأمينات على كل المخاطر وحتى
هذه فيها استثناءات، لذلك فالقول بأن التأمين يشجع الإهمال والتهاون مردود عليه،
بل على العكس من ذلك في أوربا فإن تطور التأمين ساهم في قلة الحوادث، وهناك أيضاً
ما يسمى(Bonus malus)،
وهي عروض تضعها شركات التأمين لمن لا يرتكب حوادث فيستفيد من تمديد مجاني للتأمين
مثلاً أو امتيازات أخرى، كذلك أصبحت شركات التأمين تتدخل مع المؤمنين، كأن تقتني
أجهزة إنذار مبكر لأصحاب المصانع لتقليل حدوث الحوادث، أحياناً قد تتدخل حتى عند
حدوث حوادث (كالمشاركة في عمليات الإنقاذ مثلاً عند غرق سفينة مؤمنة لديها)، فأصبح
التأمين وسيلةً للتهذيب وتقليل المضار، لكن التأمين على المسؤولية رغم الأدوار
التي قدمها فقد وقعت به اهتزازات، البعض سماها أزمة التأمين على المسؤولية، بعضها
وقعت في أمريكا منتصف الثمانينات، وفي التسعينيات ضربت في أوربا خاصةً في قطاع
الصناعات الدوائية والبيئة، فقد أبدى هذا النظام بعض القصور، بسبب طبيعة الأضرار
التي كانت تعوضها والتي أصبحت تتزايد، وشاملة تمس أعداداً غير محدودة، فالدواء
يتناوله آلاف المؤلفة، فإذا وقع ضرر ما يكون كبيراً وغير محدد، كذلك قد تقع أضرار
كنا نجهلها: كدواء مثلاً شائع الاستعمال لم تظهر مخاطره في السابق، لكنه ومع
التطور التكنولوجي تظهر أعراض خطيرة يسببها فهل يضمنها التأمين؟ وكذلك هناك
مخالفات لا تعوض بتحايلات شركات التأمين نفسها، كل هذا جعل آلية التأمين على
المسؤولية تترك وراءها مساحات فارغة وتترك ضحايا دون تعويض، وحدثت أزمة التأمين
على المسؤولية في نهاية السبعينات في أمريكا، ووصلت إلى أوربا في التسعينات، كذلك
لما بدأت تكثر الحوادث انسحبت عديد شركات التأمين من السوق، وهنا ظهرت أزمة
التأمين على المسؤولية فأصبحت هذه الفكرة التي كانت تعتبر كمنقذ، أصبحت تحوم حولها
الانتقادات وتحولت من اليقين إلى الشك.
الآلية الأخرى التي ظهرت هي فكرة التأمين المباشر(Le mutual)، عوض أن الشركات التي تصنع السيارات مثلاً هي التي تؤمن على
سياراتها، اقترح أن يكون هناك تأمين مباشر، وفي بعض المرات المؤمن هو من يكون
الضحية في المستقبل، فاتسعت دائرة المساهمين، ولأن الضرر لا يمس كل المساهمين
فستكون هناك وفرة في موارد التعويض، فظهر هذا التأمين المباشر وقدم حلولاً جيدة،
لكنه أيضاً يحوي بعض الثغرات، لأن الأخطر أنه أصبح الحديث عن حوادث كبيرة، جماعية،
تمس شرائح كبيرة، ذات كثافة عالية، تمس الذمة المالية للمجتمع، وهي حوادث في بعض
المرات غير متوقعة، ولا يمكن في بعض الحالات جبرها (كحوادث البيئة)، وأكثر من ذلك
فيها ما يسمى
الارتداد (Les retombés)،
وهي صفة الحوادث التي جعلت حتى التأمين المباشر قاصر، وقالوا أن التأمين المباشر
بدأ يأخذنا إلى جهة الضمان الاجتماعي، فوقع نوع من الانحراف.
وبسبب قصور الآليتين السابقتين ظهرت صناديق الضمان،
كصندوق الضمان الخاص بحوادث المرور، صندوق الضمان الخاص بضحايا الإرهاب، صندوق
الضمان الخاص بشركات التأمين، وصندوق الضمان في غالب الأحيان يكون تمويله مشتركاً،
جزء يدفعه المشتغلون في ذلك المجال، وفي بعض المرات تدخل حتى مساهمات شركات
الدولة، والجمعيات، وننشئ ما يسمى صندوق الضمان، دور الصندوق يكمن أنه عندما يتعذر
تحديد المسؤول، ولما تكون هناك ثغرات الضمان (التأمين على المسؤولية لم يغطي الضرر
بسبب تعدي السقف أو عدم توفر الشروط، أو أن الحادث كبير لا يغطيه التأمين
المباشر)، فتحدث حالة شغور الضمان، هناك ضحايا لكن لم يتحصلوا على تعويض أم هو غير
كافي، فيأتي دور الصندوق لتغطية ذلك النقص، هذه الصناديق نجدها في بعض الحالات:
الحوادث الكبيرة وكوارث الطيران والبيئة والاستهلاك ...،
كل هذه الآليات بدت غير كافية وغير قادرة على توفير
الأموال الكبيرة المطلوبة، وهنا بدأ الحديث عن تكفل الدولة، فالخزينة العمومية
تقوم بتقديم بعض المبالغ التي تسمح بإسعاف ورفع نوعاً ما الضرر، والإصلاح، وهو ما
يسمى: (La prise en charge de l’ETAT)؛
وكأننا حسب أحد الفقهاء أمام (Super pausé)، وكأن آليات التعويض مكونة من
مجموعة من الطبقات أو تعدد طبقات بتراتبية، أو في نظام متعدد الحلقات والدرجات،
فما هي الإشكالية التي تطرح الآن؟ هذا التزاحم ألا يهدد نظام المسؤولية المدنية؟
ألا يجعلها تتراجع؟
هنا نكون أمام اتجاهين: اتجاه كبير وكثير يقول أن هذه
الآلية تصل إلى حالة من التهديد، فقانون الدول الاسكندنافية مثلاً، ألغى تماماً
المسؤولية، وأصبح يعتمد على هذه الآليات الجديدة، فالهدف هو التعويض ثم
لكل حادث حديث، المهم ألا يبق الضحايا دون تعويض، وهذه الدول هي: (السويد،
نيوزلاندا، النرويج، وفي مرحلة ما انجلترا لكن مجلس اللوردات رفضه، وعرض في فرنسا
ورفض)، وقد نجحت الدول الاسكندنافية لأن نظام الضمان الاجتماعي لديها قوي،
فالضحايا لا يبقون دون تعويض، ثم أن هناك آلياتٍ لاسترجاع المبالغ، ولكن المهم أن
الضحية لا يظلم مرتين: "مرة عندما يصاب بالضرر، ومرة أخرى بألا يعوض".
الاستغناء أو الاحتفاظ بقواعد المسؤولية.
كيف ننظم العلاقة بين
المسؤولية المدنية وهذه الآليات؟ هل هي علاقة تنافرية؟ هل ظهور هذه الآليات يعني
زوال المسؤولية المدنية أم أن ظهورها من شأنه أن يعطي للمسؤولية
المدنية فرص أكثر كي تزداد قدرة؟ كيف تعاملت التشريعات مع هذه العلاقة؟ هل هي على
منوال واحد؟ هل تختلف؟ أين وصلت الفكرة في هذه العلاقة؟
الاستغناء
أو الاحتفاظ بقواعد المسؤولية.
مع حالة تنامي الآليات الجماعية للتعويض
في مختلف مجالات قضايا التعويض، بالشكل الذي أوصلنا إلى فرضية التزاحم بل التهديد
لتقنية المسؤولية المدنية في صميم وظائفها، ألا وهي الصفة التعويضية، بات السؤال
المبحوث عنه هو هل بالإمكان الاستغناء عن قواعد المسؤولية المدنية أم أننا لازلنا
مدعوين ومطالبين بالاعتماد على هذه الآلية؟ بالرغم من حضورنا لتزايد الاعتماد على
الآليات الجماعية في قضايا التعويض وفي مختلف المجالات.
المعالجات هنا هي من التنوع والكثرة والتعدد الذي يجعلها أحياناً عصية على
الحصر، لكن من المناسب تقسيمها إلى أطروحتين: الأولى تدعو إلى الاستغناء كليةً عن
قواعد المسؤولية المدنية بينما تجنح الثانية إلى المرافعة لصالح الاحتفاظ بقواعد
المسؤولية المدنية، وبين الاتجاهين ينبري اتجاه توفيقي يحاول رسم ملامح التعايش
بين قواعد المسؤولية المدنية والآليات الجماعية.
أولاً: الاتجاه القائل بإمكانية الاستغناء عن قواعد المسؤولية المدنية.
هذا الإتجاه ينقسم لقسمين الفقه والقوانين المقارنة:
1-الفقه: الأستاذ (André TUNC)[6] من رواد هذا الاتجاه، هو يرى أن قواعد
المسؤولية المدنية باتت عاجزة عن الإيفاء بالدور التعويضي، وأن الآليات الجماعية
في هذه المهمة تجاوزت كليةً قواعد المسؤولية المدنية تقريباً، ويقول أن هذه
التقنية لا تمارس إلا وظيفة محدودة، وأن كفالة قواعد المسؤولية لتعويض الضحايا
لازالت تمثل أمنية بعيدة التحقيق، والدليل الأزمات المتتالية التي سجلتها هذه
الآلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بذلك يرى ضرورة تفضيل الآليات الجماعية
مع احتفاظ المسؤولية المدنية بمكنتي الرجوع(Subrogation)، بل الحري بالذكر هو المشروع الذي قدّمه هذا الفقيه
سنة 1966، والذي عرض فيه كيفية التعويض الآلي لضحايا حوادث المرور وحتى الحوادث
الأخرى القريبة منها كالطب والبيئة والاستهلاك.
في الولايات المتحدة نأخذ الأستاذين: "KEETON"
و"O’CONNEL" وقت أزمة التأمين (التي شوَّشت على القضاء،
وشركات التأمين، وعلى الاستثمار، على المهنيين، حتى على المرضى)، فقد كُلف الأستاذان
لأنهما كانا من خبراء هذا المجال بالتحقيق، ووصلا إلى قناعة، وقاموا بتقرير قالوا
فيه: أن المسؤولية المدنية والتأمين عليها أصبحت آلية متهالكة، لذلك يجب السير نحو
الآليات الجماعية خاصةً التأمين المباشر. وتوصلوا لنتيجة أن التأمين المباشر فرض
نفسه وبدأ يأخذ مكان المسؤولية المدنية والتأمين عليها؛
هذا قول الفقه وحتى القضاء في أمريكا وبعض القضاء في فرنسا تماشى مع هذا
الاتجاه لفترة معينة، لأن القوانين في أوربا لم تكن تسعف الضحايا، والقضاء كان
يتعاطف مع الضحايا، فكان يجد في الفقه سنداً لتقرير التعويض، ولو أنه يعاب على هذا
القضاء أنه كان يذهب للقوانين ويلوي عنقها، ولي عنق الحقيقة للتمكن من إسعاف
الضحايا، ولو على حساب اعتبارات قانونية وقضائية كان ينعى عليها.
نذهب للقوانين المقارنة وكيف سارت مع هذا الاتجاه:
2-القوانين المقارنة: رائدها القانون النيوزلندي لـ1974 الذي
جعل التعويض على الحوادث الجسدية يتم تلقائياً، وعبر التكفل به اجتماعياً وتم
الاستغناء كليةً عن قواعد المسؤولية المدنية، لدرجة منع المضرورين من اعتماد
المسؤولية المدنية (بمنعهم من رفع دعوى)، وأيضاً مشروع آخر في استراليا قرّر إلغاء
قواعد المسؤولية كليةً في حالة المخاطر الجماعية، وأسسّ لنظام التعويض الاجتماعي،
ولكنه فشل، وفي 1968 قُدِّم مشروع في بريطانيا لمجاراة هذا التحوّل الذي حصل في
الدول الاسكندنافية ولكنه قوبل بالرفض.
ولا ننس أيضاً تجربة السويد في هذا المجال والذي بموجبه سارت هذه الدولة إلى
إحلال نظام الضمان الاجتماعي محل المسؤولية المدنية.
وفي الجزائر يمكن اعتبار الأمر 74-15
المؤرخ في 30 جانفي 1974 الخاص بتعويض ضحايا حوادث المرور المعدل والمتمم يدخل في
هذا النطاق، ويمكن القول أنه سلك ذات المسلك، على اعتبار أن تعويض الضحايا يتم
تلقائياً وبمعزل عن قواعد المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المواد من 124 إلى
140 مكرر1 قانون مدني.
تقييم وتقدير: ولكن وبغض النظر عن الأهداف النبيلة
التي حركت تلك المساعي، فإنه يمكن القول أنها تبقى محدودة الأثر بصورة لا يمكن
معها الكلام عن إجماع حول إلغاء دور المسؤولية المدنية في مجال الحوادث، فقد كانت
محددة في دول معينة وحوادث معينة فقط (الحوادث الكبيرة).
ثانياً: الاتجاه القائل بضرورة عدم الاستغناء عن المسؤولية المدنية.
وهو الاتجاه الغالب، يجمع حوله الكثير من كبار الفقهاء ويمثل توجهاً ومبدأ
قضائياً راسخاً في ممارسات القضاء المقارن، لا يحيد عنه إلا لماماً (أحياناً)،
وحتى القوانين المقارنة لازالت وفية لدأبها أو سيرها السابق وهو: الإقرار بوجود
دور للآليات الجماعية، ولكنه لا يلغ الدور الريادي للمسؤولية المدنية.
الحجة الأولى: أنه في قوانين قليلة ببعض الدول،
وفي ميادين محددة، وتحت شروط محددة، يتم الإقرار بدور كبير للآليات الجماعية،
وفيما عدا ذلك فإن الاتجاه السالف يجد مقاومة كبيرة ولا يحقق الإجماع حوله: في
فرنسا، بريطانيا، استراليا، وحتى في القانون الأمريكي.
الحجة الثانية: إعمال الآليات الجماعية لا يكون إلا
في الدول التي تحوز نظام ضمان اجتماعي متطور، فهو يحتاج لموارد مالية كبيرة ولا
يتحقق هذا المطلب إلا في قليل من الدول، ويجب الفصل بين وظيفة النظام الاجتماعي
الذي يوصف بالإسعاف، ودور الوظيفة التعويضية الذي هو
أبعد ما يكون عن هذا المسار، فالأول يحمي من الفقر المدقع ولكن لا يساهم في التعويض.
الحجة الثالثة: لازالت المسؤولية المدنية تضطلع
بدور مهم في العلاقة بين الهيئات المسددة والمسؤول عن الضرر[7].
مثال: في بعض المرات شركات التأمين تدفع تعويضات أو تكاليف لمريض، أو صناديق
الضمان أو الدولة، ثم تكلف تلك الهيئة
محاميها البحث عن المتسبب في الضرر، للرجوع عليه بدعوى الدفع غير المستحق، فشركة
التأمين تحل (حلول) محل المسؤول في التعويض، ثم ترجع عليه على أساس الدفع غير
المستحق؛
(شرح: ملخص وتكملة.)
*قلنا أن تقنية المسؤولية المدنية لعبت الدور الأساسي في التعويض، وكانت
التقنية الوحيدة التي يلجئ إليها إلى فترة طويلة، ثم بفعل عوامل معينة
وجدت نوعاً من العجز وأصبحت تترك مساحات فارغة، وتترك طلبات للتعويض دون تلبيتها
وهنا بدأت المشاكل، وبدأ الحديث عن الأزمة وقدم وتهالك نظام المسؤولية المدنية
خاصةً لما ظهرت فكرة الحوادث (حوادث بملامح جديدة)، الحادث الذي يصعب تحديد هل هو
من فعل الإنسان أو الآلة، أولاً حوادث لا يمكن توقعها ، وثانياً أنها حوادث في
غالب الأحيان جماعية ذات تأثير كبير لم تعد فردية فقط، ولا يمكن إعادة الحالة إلى
ما كانت عليها، وكذلك حوادث فيها ارتدادات لا يمكن فيها حصر الحوادث مرة واحدة
وإنما تظهر مع الوقت، الطبيعة هذه وهذا المناخ ظهرت أمور أخرى، أصبحت الشعوب
والدول تكره شيئاً يسمى فعل الطبيعة وفعل القدر، ورفعت شعار "مع كل ضرر هناك
تعويض، والتعويض عن كل الضرر وليس إلا كل الضرر"، وبدأنا نتكلم عن عدم
الملاءة المالية، أو عدم اليسر والاقتدار، لأن المسؤولية المدنية ترتبط بمدى ملاءة
المسؤول عن التعويض، حتى لما ظهر التأمين على المسؤولية أصبحت شركات التأمين تصل
إلى حد معين ولا يمكنها التعويض، كحالة مثلاً منتج صيدلاني خاص بالحوامل يباع على
نطاق واسع فالضحايا سيكونون غير محددين فلا المسؤولية ولا التأمين يكون قادراً على
التعويض الشامل والكافي، ثم ظهرت الآليات الأخرى والمتمثلة في التأمين المباشر
وصناديق الضمان، وبدأنا نتساءل بخصوص هذه الآليات: هل نتكلم عن "أو" أو
"مع"؟ فهل هذه الآليات بديلة ويمكن الاستغناء عن المسؤولية؟ أم هو نظام
بسرعات ودرجات مختلفة؟ هل هذه الآليات ستخلف المسؤولية وتحل محلها؟ أم نتكلم عن
تعايش وتكامل بينهما؟
فهذه الآليات بدأت تزيد وتكتسب أرضاً جديدة، بالنظر إلى حدود الإجابات
والاستجابات التي أصبحت تلبيها بشكل كبير؛
المقصود بالإجابات: أنها تأتي كرد للأسئلة، ومن أحرج
الأسئلة وأساسياتها في هذا المقام وهو سؤال كبير دائما ننساه: لماذا يتم
التعويض؟ على أي أساس؟ ما الذي يجعل ذمة مسؤولة عن تعويض ذمة أخرى؟ هل انحراف
سلوك الشخص الذي تتبعه الذمة؟ أم التعويض يكون بغض النظر عن هذا الانحراف طالما أن
هذا الشخص يخلق أخطار؟ أو لأنه يحقق أرباحاً فهو يغتنم من النشاط الذي يؤديه ويسبب
ضرر؟ هذه الآليات قدمت حلولاً وإجابات لهذا السؤال؛
فقبل ظهور الآليات الجماعية كان القضاة يتجهون للانحراف في السلوك، ويطلبون أن
يكون هناك خطأ، وأنه يجب التدليل على ذلك الخطأ، وكنا نتكلم عن استعادة التوازن
المفقود بالقدر الممكن (والتعويض الممكن وليس العادل)، فإذا لم نثبت الخطأ لا
نعوض، والتعويض الممكن معناه أنه ليس في كل الحالات رب العمل يعوض وإنما بتوفر
شروط صارمة، قد يصعب على رافع الدعوى تحقيقها؛
هذا التوجه كان يرجح مصلحة المسؤول عن الضرر على حساب الضحية، وكانت الصناعة
وليدة، وكان الإنسان فرحاً ومنبهراً بالتطور والمدنية؛ حتى صارت الأضرار بملامح
جديدة: غير متوقعة، جماعية، غير قابلة للدفع، لها ارتدادات كبيرة، تكاليفها كبيرة
جداً، المصالح المتضررة غير قابلة للاسترجاع، (مثال مصنع يرمي فضلاته في نهر
عذب)؛ هذا الوضع أصبح فيما بعد غير مقبول، وهناك مبادئ ظهرت في أوربا
كمبدأ "تثمين قيمة الإنسان"، كما أن هناك قناعة عند الحكام والسياسيين
بأن نسعى جاهدين دون الحيلولة من وقوع الحوادث، فإذا وقعت نتضافر بكل ما أوتينا من
جهد للتعويض ليس بسبب الإسعاف، وإنما كون الدولة ملزمة بالأمن (إصلاح الطرق،
النظافة... لتفادي الحوادث)، لكنه إن وقع الحادث يجب أن تكون جاهزة، فالآليات وفرت
إجابات رائعة ونقلتنا من جهة المسؤول عن الضرر إلى جهة الضحية، وأصبحت تركز على
الضحية، وظهر علم جديد يسمى: "La victimologie"، انتقلنا لجهة
الضحية لأن فيه انتقال من أساس الخطأ إلى أساس المخاطر، فهو لا يهتم بانحراف
السلوك وإنما من يغنم يغرم، ومن بنشاطه أحدث مخاطر يجب أن يعوض، فأصبحت إمكانية
التعويض تزيد، ما دفع المسؤولين عن التعويض إلى التأمين، ثم ظهر التأمين المباشر،
ثم صناديق الضمان، ثم الدولة أصبحت تتدخل، فهذه الآليات أصبحت تعطينا إجابات شافية
وكافية لأنه وفي أغلب الأحيان الضحايا لا يتركون ومصائرهم؛
واستجابات مناسبة نقصد بها: ردود الأفعال، أي أنها مجهزة للأموال التي تسمح
بتعويض الضحايا، فالجديد الذي جاءت به هو توفيرها الحلول والحلول البديلة،
فالأداءات المالية للتعويض موجودة بتضافر الذمم، لأن الحوادث أضرارها تظهر على
مراحل؛
كذلك نعلم أن تقدير التعويض يرجع للقاضي، ويمكن أن
يلجأ للخبرة ويمكن للطرف الآخر أن يطلب خبرة مضادة (هذه الخبرة جوازية)، أما في
الآليات الجديدة فالتعويضات محددة مسبقاً لكل نوع من الضرر؛
*جاوبنا على مبرر ظهور الآليات الجماعية وهو: أنها
قدمت إجابات وحلول للأسئلة، وقدمت استجابات وردود عملية لحق
الضحايا في التعويض حينما وفرت الإمكانيات المالية والرصيد المالي الكافي عن طريق ما
سميناه (تضافر الذمم)، وهذا ما سمح أن يوفر لنا رصيداً ومخزوناً كافياً لتعويض
الضحايا؛
أما السؤال الثاني
فهو: "مع" أو "أو"؟ هل ظهورها كبدائل لتقنية
المسؤولية المدنية والتأمين عليها؟ هل حلت محل هذه التقنية أم أنها ظهرت لتؤدي
دوراً مع المسؤولية المدنية؟
الاتجاه الأول قال بإمكان الاستغناء عن قواعد
المسؤولية ( يعني "أو")، على رأس هذا الاتجاه القوانين الاسكندينافية،
لأن لديهم واقعاً هو أن الضمان الاجتماعي قوي جداً، وكما أنها تتوفر على مخزونات
مالية كبيرة جداً؛
الإتجاه الثاني هو عدم الاستغناء عن قواعد
المسؤولية، لأن هذه الآليات مشاكلها أكبر من المسؤولية المدنية، وأن هذه الآليات
أخطر ما فيها أنها أتت بفلسفة الضمان الاجتماعي الذي يحوي الاعتبارات التضامنية،
الاجتماعية والتكافلية، بينما التعويض له فلسفة أخرى، فلا يمكن استعارة نظام
وتلقيحه في بيئة أو في سياق يختلف عنه كلية في الأهداف، والأسس والفلسفة؛
لذلك فإن الكثير من الدول رفضت هذا التعويض الآلي،
وقالوا علينا أن نبني نظاماً تراتبياً متدرجاً، وهو الذي يحدد متى وكيف نلجأ لهذا
النظام أو ذاك، وهو الذي ينسق بينهم ويجعلهم يتكافلون، وبدل الحديث عن
"أو"، نذهب إلى التكافل والتعايش بينها، وهذا ما ذهبت إليه أغلب
القوانين المعروفة، فلديها المسؤولية والتأمين عليها، ولديها الآليات
الجماعية كذلك؛ ورغم وجودها في القوانين، الإشكالية كانت في التطبيق
الجيد، ففي تلك الدول تشغيل هذه الآليات وتنظيم كيف تتعايش مع قواعد المسؤولية
المدنية، ربما هو جيد، بينما في دولنا تسير بشكل رديء فيه روتين؛
*تكلمنا عن قيمة ودور الآليات الجماعية بالنسبة
للمسؤولية المدنية، فما قيمة المسؤولية المدنية بالنسبة للآليات الجماعية؟ لما
نقول التعايش مع التكامل، إذن فهناك اعتراف، وقناعة بأننا في نظام التعويض في نظام
تراتبي، نظام بسرعات متعددة، وفيه طبقات، فما هي قيمة المسؤولية المدنية؟[8]
مصادر المسؤولية المدنية.
لما نتكلم عن مصادر المسؤولية المدنية ماذا نقصد؟ لو أعدنا صياغة هذا العنوان،
أولاً ما هي المسؤولية المدنية؟ هي أثر لفعل أو واقعة أدت إلى إثراء ذمة على حساب
ذمة أخرى (أفقرت ذمة وأغنت ذمة) ونريد إعادة التوازن، ورتبت أثراً له وجهان
متقابلان: أولاً رتبت لنا التزام ذمة مثرية بتعويض ذمة مفتقرة، أي ولادة التزام،
في المقابل أيضاً أنشأت حقاً في نفس الوقت، إذاً كل ما يهمنا أن تلك الواقعة أياً
كانت إما إرادية (التزام عقدي). أو غير إرادية (التزام عام) رتبت هذا الأثر، وهذا
ما نركز عليه، وسواء تكلمنا عن الالتزام أو الحق يجب أن نبحث عن من كان سبباً،
وهذا السبب هو الذي نتكلم عنه أنه مصدر التعويض، ما هو السبب الذي يجعل ذمة مدينة
تجاه أخرى؟ هناك منهجين:
منهج المدرسة الأنجلوسكسونية، تقول أنه من الصعب أننا نجمع ونصنف، لأنه
لا نستطيع تحديد كم هناك من مصدر، إنما القاضي عندما يضع المشرع حالات بالترتيب
(عشرين حالة مثلاً)، هنا القاضي يقوم بعملية القياس، فإذا كان الفعل يدخل في هذه
الفئات لا مشكلة، أو يذهب للقياس، لا يوجد مبدأ نهتدي به، لأن الأنظمة
الأنجلوسكسونية لا تضع تصنيفاً وإنما ترقيم، ولهذا تسمى أنها نظام حالات، بينما
منطق التشريعات اللاتينية مختلف، المشرع يرى أن الإخلالات من الصعب حصرها، ومن
الصعب معرفة حالاتها، والحل أن كل الإخلالات نصنفها في ثلاث تقسيمات كبرى، والقاضي
من خلال عملية التكييف يدخل كل إخلال في فئته من التصنيف، فهناك اختلاف بين النظام
الأنجلوسكسوني واللاتيني، لنأخذ القانون المدني الجزائري كمثال للتصنيف اللاتيني،
عند فتح التقنين إبتداءاً من المادة 124 تضع لنا الأحكام العامة، والمبادئ والأسس،
ثم بعد ذلك من 124 نجد عنوان كبير "المسؤولية عن الأفعال الشخصية"، وهي
فئة وليست حالة كما في النظام الأنجلوسكسوني، ثم في المادة 134"المسؤولية عن
فعل الغير"، ثم المادة 138 إلى غاية 140 مكرر1 فئة أخرى، يعني لدينا ثلاث
فئات، لما نذهب للمسؤولية العقدية سنجد أيضاً المسؤولية عن الأفعال
الشخصية، والمسؤولية عن فعل الغير، وما يهمنا أنه لدينا ثلاث فئات
موجودة في المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، فكيف يستطيع القاضي من فئات أن
يصل إلى حلول؟ من الناحية العملية؛ مثلاً الزبون يحضر قضية خام وبها شوائب إلى المحامي،
مهمة المحامي أن يصفي الوقائع التي لا تفيد في القضية، ثم تقسيم ما هو وقائع
مؤثرة، ووقائع أقل تأثير، ووقائع ثانوية، وهنا تظهر الوقائع المؤثرة والمحركة،
ويبحث عن رابط بينها ليشكل حلقة ، فيبحث أي الفئات الثلاث تندرج فيها؟ أي التصنيف
أنسب يفيد الزبون والأقرب لإحدى الفئات؟ ثم يقصد النصوص ويقدم طلباته، القاضي
أيضاً في أغلب الأحيان يكون أمام مصلحتين، ومنطقين وطرحين، والمنطقان متضاربان
ويأتي القاضي كحكم، من أولى المسائل التي يهتم بها هو التكييف، أي التكييفين أسلم؟
لأن التكييف السليم يؤدي إلى تطبيق صحيح القانون، والتكييف معناه أن تلك الوقائع
أدخلناها في الفئة الأنسب، ولم نخطئ فيها؛ فالمحكمة العليا تراقب في التكييف ولا
تراقب الوقائع؛
طالما أن الإخلالات عديدة ومتنوعة وهي في تزايد بسبب التطور الذي جاء بمصادر
للمسؤولية لم نكن نتوقعها، وهذا التزايد في حاجة إلى التصنيف، والتقسيم، والتبويب،
إذن فحتى نتكلم عن الحق في التعويض والالتزام بالتعويض نحتاج إلى موجه، له
أهميتان: من ناحية التدريس، هذه الطريقة تعلم الطالب الانتقال من مرحلة إلى مرحلة،
وتساعده على نظامية المعلومات التي تصله بالفئة، ومن الناحية العملية فهي أفيد،
فالتصنيف مهم جداً من ناحية التكييف، والإجراءات، والإثبات وغيرها، وهنا نرجع
للنظام الأنجلوسكسوني الذي له منطق آخر وهو ناجح، برع أحسن من اللاتيني لأن له
مناخاً خاصاً به.
المسؤولية عن الأفعال الشخصية.
من أهم المصادر وأولاها التي
نص عليها القانون المدني الفرنسي لـ1804 هي: المسؤولية عن الأفعال الشخصية، وقد نص
عليها المشرع الجزائري في المواد من 124 إلى 133 قانون مدني جزائري، فوضع لها
المبادئ والأحكام والآثار التي تتناسب مع هذه الفئة وربطها بعناصر لا يمكن بدونها
إثارة مسؤولية المسؤول عن الضرر، وهي فكرة الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ومن
الخطأ التركيز في هذا الجانب على المسؤولية التقصيرية فقط، بل الأحرى الالتفات
أيضاً إلى المواد من 176 إلى غاية 187 قانون مدني، وهي التي تفصل في أحكام
المسؤولية العقدية المترتبة عن إخلال الأفعال الشخصية للمدين، وهي أيضاً ترتكز على
فكرة الخطأ العقدي والضرر المترتب عنه وعلاقة السببية بينهما.
-Iالخــــــــــــــــــــــطأ.
لم تعْرِف المدونات المدنية تعريف الخطأ،
وإنما اضطلع بتعريفه الفقهاء، ومن أهم التعريفات هو ذلك الذي اقترحه الفقيه "PLANIOL"، حينما عرّف
الخطأ على أنه "إخلال بالتزام سابق"، دونما تفرقة ما بين الخطأ التقصيري
والخطأ العقدي، ليتولى بعد ذلك الفقه اللاحق له تحليل عناصر الخطأ[9].
أولاً:
الخطأ التقصيري.
هنا نكون بصدد مخالفة ليس لها علاقة
بالعقد، أي بعيدة عنه، لذا تسمى بـ"الخارج-تعاقدي" (L’extracontractuel)،
أو ما هو أبعد من العقد، وفي هذه
الحالة نكون في الغالب الأعّم حيال واجب عام أو التزام عام غير محدد، مؤداه ((عدم
الإضرار بالغير))، والتزام الحيطة والحذر، والحرص، وعدم الرعونة أو الإهمال في
سلوكاتنا، ولا يعرف الإخلال إلا بعد انتهاك هذا الواجب العام.
المقصود بالخطأ التقصيري.
لقد اختلف الفقه في
تحديد معنى الخطأ التقصيري، فرأى فيه البعض بأنه "عمل ضار يخالف
القانون"، في حين يرى فيه البعض الآخر أنه "إخلال بالثقة
المشروعة"، بل إن بعض الفقه يرى فيه "انتهاك لحرمة لا يستطيع من انتهكت
حرمته أن يعارضه بحق أقوى أو بحق مماثل"، ومن التعاريف التي اجتمع حولها عدد
كبير من الفقهاء هو أن الخطأ هو "إخلال بالتزام قانوني بعدم الإضرار
بالغير"، ومنه فإنه يترتب أن الخطأ هو انحراف عن السلوك الواجب أو
السلوك العادي، مع إدراك الشخص لذلك، ومن هنا يظهر أن فكرة الخطأ
تتضمن عنصرين: العنصر المادي: ويسمى بالتعدي (Transgression)، والعنصر المعنوي. [10]
1- العنصر المادي.
الخطأ هو
انحراف في السلوك، أو هو خروج عن "ضابطة السلوك المطلوبة"، وقد يكون عن
عمد وحينها يسمى بالخطأ التقصيري، وهنا تكون هناك نيّة بإيقاع
الضرر بالغير، وقد لا ترقى إلى ذلك، فالمخطئ هنا يرتكب إهمالاً ويتسم سلوكه بعدم
الحيطة، وفي هذه الحالة يسمى الخطأ الشبه تقصيري.
كيف يقاس الانحراف؟ الانحراف
يقاس بمعيار موضوعي(Inafractos)،
ومعناه أنه يجب أن يقاس سلوك المتصرف بالسلوك المألوف للشخص العادي، فإذا وافقه لا
يعد المتصرف مخطئاً، أما إذا انحرف عنه فعد مخطئاً، والأمر سيان سواء كان بالسلوك
الإيجابي أو السلوك السلبي. على أنه يجب التأكيد على أن القاضي يدخل في اعتباره
الظروف الخارجية التي تحيط بوقوع الفعل، إذ قد تتطلب ظروف الحال درجة أقوى من
الحيطة على الوضع العادي، وهنا على القاضي أن يركز على الوضع الخاص الزماني أو
المكاني، مثلاً من يقود سيارة في طريق مليء بالمنعرجات، حيطته يجب أن تكون أعلى
ممن يقود سيارة في طريق عادي، ومن يسير في الليل درجة اليقظة مطلوبة أكثر من
السائق في النهار[11].
2-العنصر المعنوي.
ويسميه
الفقه بالإدراك، فعلاوةً على العنصر المادي المذكور سابقاً يجب أن يكون
الشخص المراد مساءلته مدنياً مميزاً، فلا يسأل الصغير غير المميز ومن
في حكمه كالمجنون والمعتوه، أو من فقد وعيه لسبب عارض كالغيبوبة،
والتنويم المغناطيسي، وهذا يعني أن الخطأ يرتبط بالتمييز والإدراك، وهو ما تؤكده
المادة 125 قانون مدني بنصها "لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو
امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان
مميزاً"، فالتمييز شرط جوهري في المسؤولية.
هل في كل الأحوال عديم التمييز لا يسأل؟ الأصل أن
عديم التمييز لا يسأل مدنياً، ومع ذلك فإن المشرع المصري يجيز للقاضي الحكم
بالتعويض على عديم التمييز، ولا يوجد حكم في القانون الجزائري بعد تعديل المادة
125 بالقانون 05-10، في حين لازال المشرع المصري يحتفظ بهذه الرخصة للقاضي في
مادته 164 فقرة 1 قانون مدني مصري "...ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز
ولم يكن هنالك من هو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض المضرور جاز للقاضي أن
يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل[12] مراعياً في ذلك مركز الخصوم"، مع
التأكيد على أنه في هذه الحالة أن مسؤولية عديم التمييز، لا تنبني على الخطأ إنما
على تحمل التبعة.
خطأ الشخص المعنوي.
إن القول بتوفر
شرط الإدراك في المسؤول المدني قد يفهم منه عدم مسؤولية الشخص المعنوي، بيد أنه من
حيث المبدأ ليس هناك ما يمنع من مساءلة الشخص المعنوي مدنياً، والمعوّل عليه في
هذا الأساس هو إدراك من يمثله (أي الشخص الطبيعي)، فإذا وقع من ه
[1] : راجع قادة شهيدة، مسؤولية المنتج، بخصوص الازدواجية
والوحدة، خاصة طبيعة التكييف القانوني، وانتقاد الازدواجية.
- إما يكون تعويض اتفاقي: (الشرط الجزائي)، هنا
حكم القاضي يكون كاشفاً لا مقرراً، كاشف لحكم اتفق عليه يعطيه قابلية التنفيذ بأمر
على عريضة؛
-التعويض القانوني: الفوائد التأخيرية فالقانون هو
الذي يحدها؛
-التعويض القضائي: إذا لم يتفق الأفراد على التعويض،
يقدر القاضي حسب موجه ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب.
[3]:
بحث للأستاذ قادة شهيدة، فكرة تنازع المصالح في قضايا تعويض ضحايا حوادث الطيران،
المؤتمر العشرين، كلية الحقوق، دبي، 2012، كذلك كتاب مسؤولية المنتج جزء تطور
المسؤولية
[5] *ومن بين المشاكل التي تثيرها فكرة التأمين، أنها أصبحت
وسيلة تساعد على الإهمال، والرعونة، وعدم الإحساس بالمسؤولية، لكن هذا الكلام
مردود عليه يقوله من يجهل نظام التأمين، لأن شركات التأمين ليست مؤسسات خيرية، بل
هي مؤسسات ربحية.
هذا
الفقيه له قصة، كان ينعى على القانون الفرنسي أنه متخلف فحوصر من كل الاتجاهات من
الباحثين، في 1966 وضع مشروع يبين كيفية تعويض ضحايا المرور، فاتهم بالخبل وسمي
بـمجنون القانون الفرنسي، كان يتكلم عن صناديق الضمان، لا نخفيكم سراً أن القانون
الجزائري في 1979 استمد من هذا المشروع ووضعنا قانوناً للتعويض الآلي، وأسسنا لأول
صندوق، ولأول مرة كان القانون الجزائري سباقاً على القانون الفرنسي، ففي 1985 وقعت
مشكلة كبيرة في فرنسا بخصوص تعويض ضحايا حوادث المرور، فرجعوا لمشروع الفقيه
لـ1966 ،وسمي عليه لاحقاً مركز القانون الدولي أندري تانك، ورجعوا حتى لتراثه هو
وقلة آخرون كانوا يسمون بفقهاء القانون الأمريكي، راحوا ضحية الشوفينية
الفرنسية.
[9] ويمكن
أن يفهم خطأ أن المسؤولية المدنية هي المادة 124 فقط، لأنه عند دراسة المسؤولية
المدنية يا إمّا يتم التركيز على المسؤولية العقدية، يا إما نركز على المسؤولية
التقصيرية، لكن من الفروض أنه عند دراسة المسؤولية المدنية يجب أن ندرسهما معاً
لأنهما ليسا في كل الأوضاع متماثلة، مثال في الإثبات: الخطأ التقصيري أصعب في
الإثبات من الخطأ العقدي، فالدائن لا يجد صعوبة لأن عدم تنفيذ المدين لالتزامه
يعتبر في حد ذاته خطأ، بينما في الخطأ التقصيري أمر آخر، لأنه في غالب الأحيان
معقد، وفي بعض المرات لا نعرف إذا كان فعل الإنسان أم فعل الآلة؟ هل هذا الفعل
المسبب للضرر داخل في الأشياء التي يجب أن يتحملها أم لا، مثلاً: مريض يقوم بعلاج
آلي لا يعرف إذا كان هذا الألم داخل في العلاج أم لا؟ ويمكن أن يكتشف فيما بعد أن
هذا بسبب نقص معرفة المعالج أو لخلل في الآلة، فالإثبات صعب: علاقة السببية،
الدفوع...،
[10] شرح: تكلمنا عن الخطأ التقصيري وقلنا أن أساسه في المادة
124، ونحن نتكلم عن الأساسات قلنا أن فكرة المسؤولية المدنية في الأول كانت مختلطة
بالمسؤولية الجنائية، ثم بعد ذلك استقلت أو تمايزت، ورغم ذلك فقد تأخذ بعض
ملامحها، بدليل أن القانون الروماني لم يكن يسمح بإثارة المسؤولية المدنية حتى
تقوم المسؤولية الجنائية، ورغم استقلالها بقيت بعض الآثار، وأهم دليل على ذلك أننا
في التقسيم: نقسم إلى المسؤولية التقصيرية وشبه التقصيرية، وإلى وقت قريب نقول
الجرم المدني، والخطأ التقصيري لما يكون فيه تعدي عن عمد، ولما يكون إهمال عن غير
عمدي نقول خطأ شبه تقصيري... وهذا الاختلاف في التعاريف بغرض اشتقاق الخصائص، فمن
يقول أنه "عمل ضار مخالف للقانون"، يريد أن يجعل هذا المفهوم موسع، من
يقول أنه "إخلال بالثقة المشروعة" المقصود أنه ثقة الغير به، أنه يلتزم
بعدم الإضرار بالغير، وحينما يعرفه البعض أنه "انتهاك حرمة شخص لا يستطيع من
انتهكت حرمته أن يعارض حقه" (كشخص يصيب أفراداً وهو في طريقه لانقاذ غريق فحق
الغريق في الحياة أسمى).
[11] شرح: العنصر المادي هو التعدي على حق يحميه القانون يرتب
التزام في جهته لصاحب هذا الحق في التعويض، هذا الجانب المادي يعبر عن
الانحراف عن السلوك المألوف (الضابطة)، التقدير الموضوعي لسلوك شخص في ظروفه كيف
يتصرف)، في بعض الأحيان القاضي يطبق هذا المعيار، وفي أخرى يضيف معيار آخر التقدير
للظروف الخارجية (المكان، الزمان).
[12] *التعويض العادل: هو
تعويض جبر الخواطر من الشريعة، فالقاضي يعطي تعويض تقريبي يمكنه من تعويض بعض الأضرار؛
المشرع يعاب عليه حذفه حكم غير المميز لأنه استثناء، وجوازي، وليس تعويض بالمفهوم
المدني وفيه الصفة الاحتياطية، وخالف حكم الشريعة وجمهور الفقهاء.
تحميل pdf

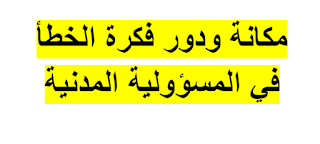

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم